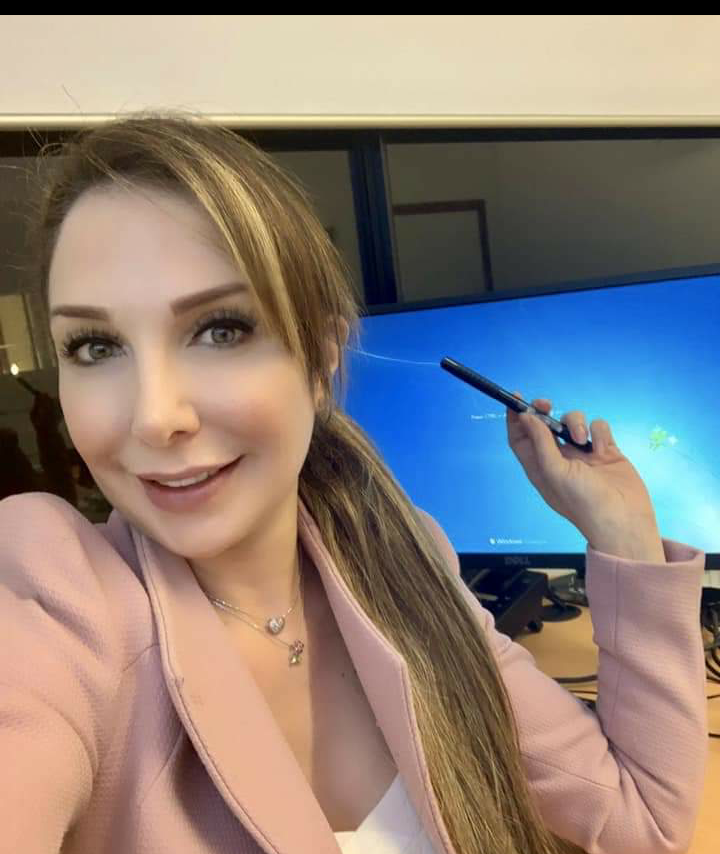كوابيس الأستاذ فرحان

زهير كريم
تنطوي سيرة الأستاذ فرحان، مدرس التاريخ في ثانوية بغداد، على سلسلة غير متناهية من الكوابيس، ساهم تكرارها مع مرور الوقت في تشكيل حزمة من التبعات النفسية المجهدة، وأيضاً تخلل ذلك بعض العوارض الصحية، كان أقّلها خطورة إصابته بالصلع المفاجئ، ثم بالرعشة النهارية التي جعلته غير متماسك حتى في حمل استكان الشاي إلى فمه، أصيب كذلك حسب تشخيص جاره أستاذ اللغة العربية بما سماه اضطراب الهندسة اللغوية، فقد كان يعاني فرحان الذي صار اسمه يشبه المفارقة السوداء من انهيار المعنى في بناء الجملة فتبدو الرموز والإشارات التي تصدر منه عصيّة على تقديم شرح واضح لما يودّ توصيله، رافقت ذلك بعض النشاطات الغريبة، مراقبة الغيوم مثلاً، والتي يكوّنها من نفثه المتواصل لدخان السجائر، وكان بصره معلقاً أثناء ذلك وشفتاه تتفاعلان بصيغة الهمس مع كائنات يجدها تمتلك قوة توجيه خطاب حياته الدرامي وسرد النكات أيضاً إذا استدعى الأمر، إنها مثل فواصل لطرد الملل. السؤال الذي طرحه في آخر صفحات هذه السيرة على زوجته، يعبِّر عن هذه المأساة بشكل مكثَّف، وكان يتعلق بالكيفية التي يكون فيها المرء موجوداً في مكان ما، ولا يعرف في الوقت ذاته اختلاف ذلك الوجود عندما يكون في مكان آخر، وكيف يحدث التماثل بين عالمين منفصلين في الحركة والتعبير، حيث يختلط ما هو خاضع لاشتراطات العالم الداخلي، بما هو محكوم بقوانين الفيزياء التي هي سمة لعالم الواقع. ولقد كان الأستاذ فرحان قد تجاوز الستين بعدة سنوات، لكنه لم يستطع التخلص من الغلاف الرمادي الذي يصبغ أوقات نومه المؤلمة، أوقات سببت له ثقوب كبيرة تشبه ما تقوم به رصاصات تطلق عن مسافة قريبة على الجسد الآدمي، ولقد انتشرت هذه الثقوب في وجدانه، ولم يدرك إلا فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بمشاعر تتفاعل في بركة النوم الضحلة فتترك ثقوباً واسعة، بل إن وجدانه الواقعي أصبح هو الآخر مليئاً بمثل هذه الأشياء، حيث إنه استسلم على النحو الذي لم يعد قادراً فيه على طمر هذه الثقوب، وبسبب ذلك بدأ يعاني من اضطراب شامل في فكرة الاستيقاظ نفسها، حسناً، في فترة لاحقة، عانى من صعوبة تزداد يوماً بعد يوم في استعادة حياته الواقعية، ولقد حدث ذلك في فترة صعود الخط البياني لكوابيسه، وبالقدر الذي جعله لا يعرف بالضبط، هل أن أولاده الثلاثة وابنتاه أنجبهم في النوم أم اليقظة، هذا لأنه لم يعش اللحظات الحميمية في أيٍّ من المكانين، واحتفظ حتى بمشاعر المتعة كاملة مع زوجته، ولم ينس ما يقوم به من حركات لا تخلو من المهارة، إنها أشياء تطورت لديه بفعل مشاهدته في زمن مضى لأفلام )البورنو(. في النهاية، قادته هذه الكوابيس أو الأحداث إلى نوع من التواطؤ في الفهم، وتشكّل لديه ما يشبه الإيمان بأن مرحلة النوم نفسها هي حقيقة الوجود، أما ساعات الاستيقاظ، فهي الإقامة في العمى أو التيه، أو أنها فواصل، مجرد فواصل سريعة تحدث فقط من أجل الاستعداد للغوص بعمقٍ أكبر في فضاء وجوده الأصلي. وبالنسبة لزوجته، تعاملت مع حالته باعتبارها مرضاً نفسياً، وكانت رحلة البحث عن حل قد بدأت منذ وقت مبكر. حسناً، هو لم يمانع في توظيف الصلاة لله، كذلك النذور التي تعد زوجته بها ربّ العباد. الحقيقة أن المسكينة كانت تفي بوعودها رغم أن الأحوال انحدرت بسرعة حجر من على جبل. لم يرفض كذلك الزيارات المكّوكية لأضرحة الأئمة والأولياء وتجريب البكاء عندهم.
: عليك أن تبكي يا فرحان.
: أنا أبكي يا عزيزتي، لكن لا شيء يخرج مني فتسمعينه.
: ابكِ يا فرحان، ابك وسوف يسمعونك، عليك أن تسمعهم شيئاً يا فرحان.
ويبكي فرحان، كما لو أنه يعصر روحه حتى تخرج إلى الفضاء الصاخب بالأدعية والعويل، كان يفعل ذلك تعاطفاً مع الزوجة المسكينة، حتى أنه وافق أن يحمل أكثر من حجاب كتبه شيوخ وسادة مجربون، شرب كذلك أشياء غريبة وصفها بعض من يشتغلون في أعمال السحر. حتى العارفين بخلطات الأعشاب والطب النبويّ، ساهموا في هذه الحفلة الرمادية. في النهاية، شارك الأطباء المتخصصون في علاج الكوابيس وما شابهها من اضطرابات النوم في البحث عن حل، لم يجدوا أيضاً سوى بعض الحبوب التي قالوا إنها لعلاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية، زوجته تصالحت مع حظها أخيراً، واعتبرت أن حياتها يمكن أن تستمر مع رجل لا يعرف هل هو نائم أو مستيقظ، ميْت أم حيّ. وفي البداية، كان نمط الكوابيس هو تدويرٌ لمشاهد السحل في الشوارع، السلسلة الكابوسية التي كانت تتشكَّل في هذه المرحلة، تُظهر يديه مربوطتين بحبلٍ طرفه الآخر معقود في مؤخرة سيارة، أو ملفوف على عضو حصان، أحياناً يكون الحبل مربوطاً إلى قرن )تيس كبير( مجنون، أو إلى عربة يجرها حمار سمين تناول علفاً جيداً للتوّ، يستغرق المشهد الواحد عادة وقتاً طويلاً، ولا يسمع خلاله تنفيذه غير زغاريد النسوة وتكبيرات الشيوخ وضراط الصبية قبل أن يستيقظ، حينها يشعر أن جسده خارطة من الكدمات والثقوب غير المرئية، عظامه ملحوسة بسبب احتكاكها على الإسفلت، ورأسه عبارة عن كرة تنتشر فيها النتوءات، ثم يشم في جسده رائحة روث الحيوانات وبول كلاب. زوجته كانت تساعده على النهوض، يدخل الحمام ويتغوط كل شيء، مشاعر الخوف، رائحة الدم، ثم يتقيأ بقايا الصراخ قبل أن تنتشر انبعاثاته الفاسدة في فضاء المنزل، تدخل للجيران من النوافذ أو تغادر فتدخل المقاهي والأسواق والمدارس أيضاً. ولم يعترض أحد، فمعظم الناس كانوا متفهمين جداً ومتصالحين مع الحدث، ومؤمنين بفكرة أن العالم آمن، بشرط المزيد من الصمت، وتقوية هرمونات
الخوف بكل وسيلة متاحة.
وفي مرحلةٍ لاحقة، كانت سلسلة الكوابيس تحتوي على تفاصيل غنية ومشاهد مصنوعة بذكاء، يحدث مثلاً أن يصل بعض الرجال ذوو الشوارب الكثّة، كائنات لا يتمتع أي منها بأقل ما يمكن من اشتراطات اللياقة، يدخلون كأشباح من النافذة، أو
يخرج أحدهم من التنور مثل )الطنطل( أو يهبطون من السطح، حتى إذا حدث وأن دخلوا من الباب، لا يعرفون الطرق عليه، بل يركلونه بأحذيتهم ويبصقون معجماً كاملاً من البذاءات، يقتادون مدرّس التاريخ النحيل )فرحان( وهذا يحصل باستمرار إلى أماكن مجهولة يخمنها هو بناءً على معطيات مسبقة، بسبب خبرته في كوابيس كهذه، يفتشون بيته ويأخذون الكتب الماركسية التي يحتفظ بها. كان ذلك قبل تحوّله في مرحلة لاحقة للفورة اللاهوتية، ولم يكن ذلك عن قناعة أو سعياً إلى الثواب، بل لأن العالم يتغيّر فحسب. على كل حال، يأخذون أيضاً الأوراق والمجلات الإباحية، وكتاب الأدعية الصغير الذي تحتفظ به زوجته، وكاسيتات الأغاني وأشرطة الفيديو، ثم يجد نفسه في عتمة تنتشر في نسيجها الرطوبة وعفن الذكريات ورائحة الخراء ودبيب القمل، يحدث كل هذا قبل أن يقضي ما تبقى من ليلته معلقاً مثل خفاش ضخم، ثم يستيقظ بطريقة السقوط من على السرير، يشعر حينها أن قدميه متورمتان بسبب اندفاع الدم من الأسفل إلى الأعلى، بينما فظاعة الألم تسري في أظافره، والأزيز أو ما يشبه ذلك يسري كموجات كهربائية في عضوه التناسلي وإبطيه، أشد ما كان يؤلمه، إحساسه بما يخلفه سقوط الهراوات على كل جزء من بدنه وحرقة كبيرة في مخرجه. وفي الواقع، إن كوابيس (الأستاذ فرحان) كانت تتمتع بسمات فيروسية من ذلك النوع الذي يطور نفسه باستمرار، في مرحلة لاحقة مثلاً، تظهر السماء فيها مشبعة بالدخان ورائحة البارود الخانقة وربما الغازات السامة أيضاً، يسمع فيها هدير مدافع ضخمة، وكان يشعر أن أذنيه عاجزتان عن فهم الكثير من الأصوات.
وفي إحدى المرات، رأى أن النيران تشتعل في جسده، شمَّ رائحة لحمه المشوي،كان يركض بجنون باتجاه نهر تخيّله قريباً. وفي مرة، تأكَّد له أنه أسير، معزول في أعالي سجن جبليّ، حزنه كان كبيراً في ذلك الكابوس، كان يبكي في الليل
والنهار، لفراق أولاده وزوجته الحبيبية، وكان كلما أستيقظ يحتضنها كما يحدث لرجل فارق زوجته عشرين عاماً، يبحث في البيت عن أولاده وبناته فيجد أنهم لم يكبروا كما ينبغي للأب الذي يغيب لزمن طويل عنهم عشرين عاماً، تدور عيناه للبحث، فيتأكد أنَّ أم عياله لم تتزوج أحداً في رحلته التي كان يعرف أنها وجيزة وأنها مجرد كابوس آخر، تحصل له تلك المعرفة بما كان يحمله من خيط رفيع من العقل أثناء الفواصل، يستطيع أن يميز أثناء ذلك الخيط الأبيض من الأسود، أحداث كثيرة مرت على فرحان تتخللها بعض أوقات النوم الخالية من أية حركة، رحلة كأنها الفراغ أو العدم. بعض الأوقات تمرُّ وفي داخله شعور قاتل بالجوع. مرة واحدة شاهد نفسه أمام صف أطفال موتى أجسادهم جافة تماماً. وفي مرات كثيرة، صادفته نساء عاريات، هكذا ربي كما خلقتني، نساء واضح على وجوههن أنهن مصابات بفقر الدم والتهاب اللثة وجفاف الجلد، يشرن للعابرين بعلامات يعرفها الجميع، خاصة من يقود شاحنة طويلة، أو ضابط في الشرطة والميكانيكيون. في مرات عديدة شاهد بعض الناس يتسلقون الأسوار. الحقيقة أنهم كانوا يتزاحمون على صعود السلالم وكلٌّ كتابه في يمينه. فكَّر أن يقوم بهذا الفعل، لولا أن زوجته وأولاده، قبضوا عليه، قيّدوه جيداً، قالوا له، إن كوابيس كثيرة لم تزل بانتظاره. وبعد أقل من ثلاث سنوات من مغادره آخر الكوابيس العظيمة، دخل المرحلة كلّها، كان يرى الجثث تنزلق بخفة مع مجرى النهر، يصف لزوجته كل يوم هذا المشهد ويضيف: إنها جثث منفوخة وبوجوه مشوّهة، جثث دون رؤوس أو برؤوس مثقوبة أو مهشمة بحجر أو بآلة حادة، وحتى أنصاف آدميين مثل أكياس سوداء من البلاستيك. لم يتحمَّل كل هذه المرارة حتى أنه وظَّف الفواصل بين الكوابيس كطريقة لخلخلة المشهد، كان يجعل مؤقت الساعة يرن كل خمس دقائق، يقوم ويدخن طوال أيام متواصلة، يأكل ويشرب، يشاهد التلفزيون وكان مليئاً بالجثث أيضاً، يسمع الأحاديث وكلها تدور حول الموضوع نفسه حتى صارت الفاصلة كابوساً مكثفاً، أما الناس كلهم كلهم بالضرورة يفتقدون إلى النزاهة، ولا يوجد ولا حتى خيط شفيف من أمل، بل إن العلامات التي حفظها خلال تاريخ حياته تتحول إلى غابة محروقة، في آخر أيام )فرحان( اختلط عليه تماماً ما كان حركة تنبعث من الداخل أو ما يأتي من الخارج، انطفأت عيناه ولم تعد حواسه تعمل بشكل منتظم، وتحت ضغط هذه الفوضى التي جعلت سيرته دون فواصل، خرج ترافقه عتمة العمى وظلام الروح، في تلك اللحظات، لم يعد يعنيه فيما إذا كان الظلام قد تسلَّل إلى كل زوايا المدينة أو أن ثَمَّ مسربٌ
صغير للنور يدحض الصورة الشاملة لهذا المشهد المنحطّ. سمع شيئاً ينبعث من مكان ما، شيء يعرفه جيداً، لقد صادفه في كوابيسه على مدى ستين عاماً، أحس بأنه يخترقه، ولم يمرّ سوى وقت قصير حتى وجد جسده في النهر، أحسّ
ببرودة الماء، ولأول مرة، يتذوق طعم الفاصلة القصيرة، الحياة التي بين ميتتين واسعتين، بينما جسده كان خفيفاً، خفيفاً كريشة حرة وهو ينزلق على الموج بين مجموعة كبيرة من الجثث في رحلتها الطويلة إلى نهايات العالم.
_____________
* من مجموعة: فرقة العازفين الحزانى