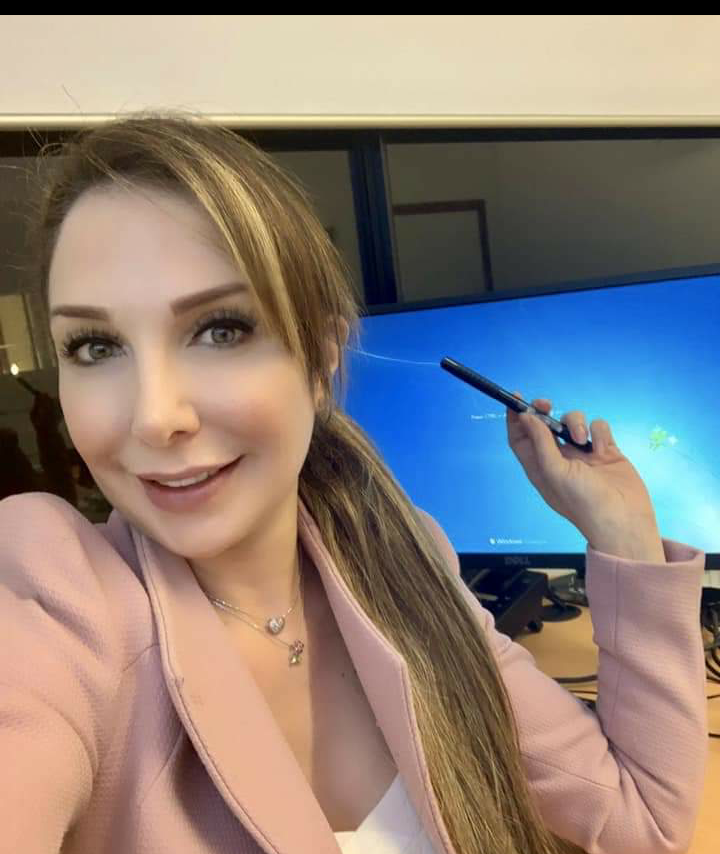فصل من رواية “أرض المؤامرات السعيدة”

وجدي الأهدل
الثلاثاء (64)..
كم أتذكر بوضوح تلك اللحظات المجنونة، التي مرت على غفلة مني، ثم شطرت حياتي إلى نصفين، وبدأ منها عالمي المعهود المستقر، يمر بتحولات جارفة، تفوق قدرة أي كائن بشري على التحمل!
في ظهيرة يوم ثلاثاء صيفي حار، تنحني فيه الرؤوس تجنباً للغبار، استدعاني رئيس التحرير (رياض الكيّاد) إلى مكتبه، وكلفني بالذهاب إلى محافظة (الحُديدة) الساحلية لعمل تغطية صحفية، نزيهة ومحايدة، للتأكد من صحة حادثة مزعومة يُقال إنها حدثت بالأمس في أحد أودية (تهامة) النائية.
رئيس التحرير الذي تختبئ نظراته المُلتبسة خلف العدسات السميكة لنظارته الطبية، تكلم باقتضاب شديد عن المهمة التي كلفني بها، ثم مدّ يده إليّ وناولني خمس رزم مالية، كلها من فئة الخمسمائة ريال، وطلب مني الاستعداد للسفر فجر اليوم الثاني.
لم يكن التحقيق الصحفي الذي ينتظرني هو ما شغل بالي في تلك الدقيقة التي لا تنسى، وإنما تخيّل مكابدتي للحرارة الجهنمية في تلك الأودية، واحتمال أن أصاب بالملاريا إذا ما اضطررت إلى المبيت هناك. عدتُ إلى بيتي مطمئناً وواثقاً أن لا شيء يمكنه، مهما بلغت قوته، التشويش على مسار حياتي أو خلخلتها.
فتحتُ الباب فهرع أطفالي الثلاثة لملاقاتي. عانقتهم واحداً واحداً، ثم اتجهت إلى المطبخ ورائحة زكية تجذبني إليه جذبا، وصوت نشيش الزيت أحلى من تغريد البلابل! رأيتُ زوجتي مشغولة بتحضير الغداء. تلاقت عيوننا بلهفة، وفي لحظة كان كل واحد منا يُطوّق الآخر ويُقبّله.
خلعتُ ملابسي في غرفة النوم، ورميت رزم النقود في أسفل الدولاب قرب جواربي المتسخة. سخرتُ من نفسي لأنني لم أتعود بعد على حب ورق البنكنوت ومعاملته باحترام.
لاحظتُ وأنا أغتسل في الحمام، أن دملة صغيرة قد نمت فوق قصبة أنفي. بدت حمراء صغيرة وتطل ببلاهة على تضاريس جسدي العاري. تحسستها بإصبعي الوسطى، وخمنت ما تضمره لي.. إنها تنوي عندما أنزل من الجبال إلى تهامة، أن تنتفخ وتمتلئ بالقيح والصديد مستغلة المناخ المُواتي، حيث تُحلّق درجات الحرارة فوق الأربعين مئوية، والهواء رطب يفتح مسامات الجلد. نظرتُ إليها في مرآة الحمام، وقلت لها إنها إذا فعلت ذلك، فسوف أخزها بالإبرة، وأُطهرها بمُطَهِّر. رفعت سبابتي وهددتها “سوف أُطهرك أيتها الدملة الحقيرة!”. فجأة أدركت المفارقة التي وقعت فيها، وضحكت من نفسي، لأن اسمي (مُطَهَّر) والدملة بعد جرحها وتطهيرها ستصبح (مُطَهَّرة). آه يا لنا من زوجين رائعين! خطر ببالي وأنا أُسرّح شعري تساؤل عن السبب الذي دعا أهلي إلى تسميتي بهذا الاسم المُريب (مُطَهَّر).. من طهرني؟ ومتى؟ أم أن ذلك شيء لم يحدث بعد؟؟ كلا، لا أريد أن أُعامل كدملة ويخزني أحدهم بإبرته! خرجتُ من الحمام وأنا أشعر بالضيق من الاحتمالات التي يطرحها اسمي.
جهزت زوجتي مائدة الغداء بعشرة أصناف، وفي الوسط استلقت سمكة “ديرك” كبيرة. أدركتُ على الفور أنها قد خرجت في الصباح إلى السوق، وأنفقت كعادتها مبالغ كبيرة لشراء لحوم وخضار وفاكهة تفيض عن حاجتنا، ويذهب معظمها إلى برميل القمامة. أنا لست بخيلاً، ولكن هذا الإسراف في تكديس الطعام على مائدتنا لا ترتاح له نفسي، ينتابني شيء من تأنيب الضمير.
تزوجت (حورية) قبل خمس سنوات، بعد قصة حب ترددت أصداؤها في جنبات الكلية. وفي السنة الأولى من زواجنا غرقت في الديون، بسبب ميلها الذي لا يقاوم لإنفاق المال على الفساتين والنزهات والأكل في المطاعم الفاخرة. بذلت معها غاية الجهد لتُبدّل من سلوكها هذا، ولكن في نهاية الأمر هي التي بدّلتني تبديلا!
أثناء الأكل لاحظتُ أن (هايل) ولدي البكر، البالغ من العمر أربع سنوات، كان يهمس في أذن أخته (نجاة) وهو يضحك. كان مزاجي مُعتكراً، فعبست في وجهه وسألته “ما الأمر؟”. فأشار إلى أنفي وقال: “حبّة.. قرصتك النملة”. ثم انفرطت ضحكاته دون حساب. شعرت بالقلق، وتساءلت في نفسي إذا كان هذا الطفل الذي هو حمار تقريباً يستطيع ملاحظة تلك الدملة بسهولة، فكيف سيكون الحال مع الآخرين؟ هل سيلاحظونها؟ وإذا لاحظوها هل ستثير ضحكاتهم؟ اللعنة! لم يكن ينقصني ليكتمل شقائي سوى انتفاخ مضحك يُشوّه وجهي.
بعد الغداء، التقطت رواية ألمانية، “آل بودنبروك” لتوماس مان، وتمددت على السرير، كنت متأكداً أن لاشيء سيأخذني إلى نومة قيلولة بالضربة القاضية سوى كاتب ألماني أصيل!
بين النوم واليقظة، شعرت بأحدهم يشدّ ما بين فخذيّ، ولوهلة شككت أن الكاتب الألماني هو الذي يفعل ذلك، ربما لكي أتابع قراءة روايته العتيدة، وحين شعرت باليد تنتقل إلى منطقة مجاورة، قلت في نفسي فلأنهض وأفتح عينيّ قبل أن ينتزع ذلك الكاتب الألماني الوقح خصيتيّ! قشّرتُ غفوتي اللذيذة ونظرت، فإذا هي زوجتي تشاطرني السرير كما خلقها ربي.. آه تلك السمكة لم تكن لوجه الله! وكأي فحل ينحدر من قبيلة عربية عريقة الحسب والنسب قمت بالواجب وزيادة.
سهرت في الليل لمتابعة مباراة ألمانيا في كأس العالم، زوجتي (حورية) التي كانت تتصنّع أمامي أنها تشجع الفريق الألماني، خوفاً من الطلاق، تجرأتْ وسألتني لماذا أناصر الألمان وكأن خالتي متزوجة من مستشارهم، فأجبتها في الاستراحة بين الشوطين أن الألمان هم سادة أوروبا، ونحن المتحدرين من أصلاب شيوخ القبائل نعتبر أنفسنا سادة البلاد، أي أنه يجمعنا الانتماء الطبقي ذاته! سألتني، وخدّاها يتضرجان بالحمرة، عن البرازيل، يبدو أنها تشجع هذا الفريق في السر، فقلت لها إن البرازيليين هم أولاد شوارع غير متحضرين، وأنا لا أُشجع الرعاع! انتهت المباراة بهزيمة ألمانيا وخروجها من كأس العالم. ذهبت للنوم متظاهراً بأنني غير متأثر بهزيمة أسياد العالم، تهالكت على السرير وغطيت رأسي باللحاف، جافاني النوم ساعة أو ساعتين وأنا أبكي مقهوراً، ودموعي تسيل دون توقف.
________________
*الفصل الأول من رواية “أرض المؤامرات السعيدة” للكاتب اليمني وجدي الأهدل، الصادرة حديثاً عن دار نوفل- أنطوان هاشيت في بيروت.